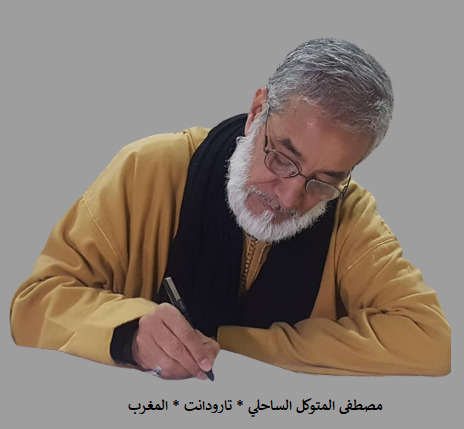الفيسبوك والوجدان الإنساني

الطواوسا عزيز
لماذا نلج للفيسبوك؟
كثير من الناس تَلِج الفيسبوك لتمضية الوقت من خلال متابعة الأخبار والفيديوهات المسلية…إلخ. لكن البعض يدخله بحثا عن ذاته التي ضاعت لسنين تحت وطأة الرقابة المجتمعية اللصيقة وأحكام القيمة من قبيل: “عيب”… و”حشومة”… و”هذا لا يجوز”. هذه الأحكام التي تُداخل النفس مع الوقت، لتتحول إلى رقابة ذاتية لصيقة تنغص على الإنسان حياته وتمنعه من الكلام. فيجد نفسه يقمع ذاته بمجرد أن يفتح فاه مرددا بطريقة أوتوماتيكية “سيضحكون علي” “سيسخرون مني”.
في الفضاء الأزرق الأمر مختلف. خصوصا بالنسبة لمنتحلي الأسماء المستعارة. حيث فسحة التعبير أكبر. ومع ذلك تظل هناك رقابة تَحُدّ من الحرية حتى في هذه الحالة:
الأولى هي رقابة الكرامة، فحتى ونحن متخفون وراء أسماء مستعارة تبقى كرامتنا واحدة، ومتى ما تعرضنا للإهانة فإننا نحمل معنا جرحنا النفسي النرجسي إلى أرض الواقع. فالأنا لا تتجزأ وحبل الكذب على النفس قصير.
الثانية تكمن في أنه مهما كتبنا وصرخنا. إذا لم يَرَنا أحدٌ ولم يتفاعل معنا الآخرون. فإن صرختنا تظل صامتة عبثية. فمن خلال كتم صوتنا بالتجاهل يجعلنا الآخرون نقتنع بأن صورتنا الحقيقية التي طالما توهمنا أنها جميلة، هي في حقيقتها غير مثيرة للاهتمام. يُشكل هذا الأمر صدمة وخيبة أمل مصحوبة بالإحساس بالإهانة والعار، وهي كفيلة بأن تقمع أكثر من واحد. وكأننا بصدد عودة الرقابة، لكن في حلة جديدة سلبية عنوانها الإهمال.
ومع ذلك، يبقى الفضاء الأزرق فضاء أرحب من الواقع للتعبير عن الذات، سواء تعلق الأمر بالأفكار أو المشاعر.
التعبير عن الأفكار
كلنا ينتمي إلى وسط اجتماعي لم يختره أو يشأ أن يكون فيه يوما. بل فتح عينيه ليجد نفسه محاطا بأناس قد لا يَمُتُّون إلى فكره وقناعاته بصلة. في الفيسبوك الأمر مختلف تماما. فأنت مَن يختر أصدقاءه، وأنت من يربط علاقاته بما يناسب أفكاره متجاوزا أي إكراهات جغرافية. ما يسمح لنا بالتعبير عن آرائنا ومشاركتها ومناقشتها مع الآخرين. طبعا يبقى اختيار الأصدقاء أمر نسبي قد نُوَفّق فيه وقد لا نُوَفّق. ومع ذلك يبقى بإمكاننا دائما الاستدراك بقطع صلتنا بمن لا يُناسبنا وتعويضه بعشرة أصدقاء جدد بمجردة كبسة زر.
أما في الواقع فالأمر مختلف تماما، وأنت تفكر ألف مرة قبل أن تُعبر عن قناعاتك للآخرين. وتتلمس ردّات فعلهم أولا قبل أن تُقرر الاستزادة أو الإحجام. لِعلمك أنك متى ما صارحت أحدهم بما يكره فلربما تَحْكُم على نفسك بتحمل تبعات خصومة مزمنة ومكلفة، قد تستمر لسنوات من الصراعات المباشرة وغير المباشرة، التي تستنزفك نفسيا بين عداوة وبغضاء ومؤامرات ومحاولة تأليب الآخرين ضدك…إلخ.
التعبير عن المشاعر
في واقعنا اليومي، التعبير عن المشاعر أمر غير مستحب كثيرا، ويتم في حدود معينة ومعقولة، ليس لأننا غير متصالحين مع أنفسنا ومشاعرنا، بل لأن كثرة التعبير عن المشاعر يتنافى مع الواقع. وإجمالا يمكن تقسيم المشاعر من حيث الفالونس valence إلى مشاعر إيجابية (كالرغبات)، وسلبية (كالمخاوف والآلام).
التعبير عن الرغبات
قد تسمع أحدهم يردد على مسامعك:
“كم أحب فلانة، أنا لا أستطيع العيش بدونها وأتمنى يوما أن أحظى بها”
أو “أتمنى أن أصبح طيارا…ليتني أستطيع تحقيق هذه الأمنية يوما ما”
أو “كم أتمنى أن أشفى وأتمتع بصحة جيدة ككل الناس”
في كل هذه الحالات هناك حُلم أو رغبة تعبر عن نقص ما. شيء ينقص صاحبه ويسعى للوصول إليه كيما تكتمل ذاتك به. في انتظار ذلك يبقى في حالة من الضعف والهوان. يمكن أن تنتهي بتحقيق الحلم، ويمكن أن يفشل الإنسان في تحقيق مبتغاه وتستمر بالتالي حالة الضعف، منضافا إليها الحزن والإحباط. فالرغبة هي بمثابة تعبير غير مباشر عن النقص أو العجز. ينضاف إليه عجز المتلقي الذي يستمع إليك وأنت تفصح له عن رغباتك ولسان حاله يخاطبك قائلا “وماذا تريد مني أن أفعل لك؟ هل ستتوسل وتتضرع مثل الأطفال المدللين. هيا تجلد وترجل واعمل بجد لتحقيق أحلامك”. من أجل كل هذا تجد كثير من الناس يفضلون عدم الإفصاح عن رغباتهم. ليس خوفا من مس العين. بل خوفا من انكشاف ضعفهم خصوصا إذا فشلوا في تحقيق حلمهم ليبقى أبد الدهر عنوان عجزهم (مسكين كان باغي يولي مهندس). وبالتالي غالبية الناس يَدّعون عدم الرغبة في الأشياء وإن كانت نفسهم متلهفة إليها. (يخ منو وعيني فيه).
التعبير عن الألم
التعبير عن الألم ليس مجرد وسيلة تواصل لبث معاناتنا بحثا عن المواساة والدعم بل هو أيضا تعبير بدرجة ما عن فشلنا النسبي في تدبير هذا الألم وهذه المعاناة. فأول خطوة في مواجهة الألم هي تحمله والبحث عن حل وعلاج سريع له. لكنه حينما يتمادى ويتعدى قدرتنا ويصل بنا لأقصى حدودنا، فإنه يضعنا أمام عجزنا ويدفعنا نحو نكوص طفولي مستسلمين في ضعف على غرار أي طفل عاجز عن تحمل مسؤوليته لوحده. أي أنه تعبير مرة أخرى عن الضعف. لهذا فالمجتمع والدين يشجعان الأفراد على الصبر والجلد والتحمل عوض الشكوى الذليلة والبكاء (فاهدمْ فؤادي ما استطعتَ فانَّهُ. سيكون مثلَ الصَّخرة الصَّمَّاءِ. لا يعرفُ الشَّكوى الذليلَة والبكا. وضراعَة الأَطفالِ والضّعفاءِ.). ونحن كلنا ننفر من الأشخاص الضعفاء كثيري الشكوى. ليس لأننا أقوياء. بل لأننا كلنا ضعفاء. لكل منا نقاط ضعفه وعقده وإحباطاته ومعاناته. الفرق الوحيد هو أننا نكابر ونعاند. عامل النظافة النشيط الذي تراه يحمل أزبالك بهمة. بائع الخضر الذي يجر عربته الثقيلة وهو يتصبب عرقا والابتسامة تعلو محياه. بقال الحي القادم من البادية والسجين طوال حياته في مساحة لا تتعدى بضعة أمتار. لكل منهم آهاته ومطباته النفسية وأوجاعه. لكنهم جميعا دفنوا أوجاعهم في مقبرة النسيان وتناسوها حتى اضمحلت ثم اختفت بلا رجعة عن ساحة الشعور. لكن لو أنهم بدأوا يَتَسَلّوْن بنبش قبور الماضي، فإن الأشباح المرعبة لا محالة ستعود. لهذا يتفادون مرافقة الضعيف الشاكي الهين، الذي يهز شكيمتهم ويهدد عزيمتهم، فتجدهم يرددون في كل وقت وآن. “خلي داك الجمل راكد”. الكل يكابر ليعطي صورة جميلة. حتى الطبيب التي تزوره لربما يخفي ألمه ليعطيك صورة إيجابية ويمنحك القوة والأمل…فالاستقواء الجماعي يساعدنا على الخروج من ذاتيتنا ومتاهتنا النفسية اللانهائية ومن نسبية أفكارنا وهواجسنا الدفينة وتشاؤمنا، لنبني عالما موضوعيا مشتركا إيجابيا مفعما بالأمل تشرق شمسه على الجميع. لكل هذا يدفع المجتمع أفراده إلى عدم المبالغة في التعبير عن مشاعرهم.
على النقيض من ذلك. قد يتطرف المجتمع في الاتجاه المعاكس أي رفض كل تعبير عن المشاعر. فيتمادى بالتالي كل منا في التظاهر بالقوة حتى نصبح مسطحين بدون أحاسيس. لا نُبدي فرحا ولا حزنا ولا حبا ولا رغبات، حتى مع أقرب المقربين إلينا (ثم قست قلوبهم من بعد ذلك). يصير الواقع برغماتيا عمليا بامتياز. كل غاية تُحسب بميزان الربح والخسارة. أما المشاعر فتُنْبَذ وتنسب للنساء الضعيفات فقط. لدرجة أنك تجد أقصى أحلام بعض الزوجات هي مشاهدة دمعة على خد زوجها. هذه القسوة أو التحجر الذي يتسم به المجتمع (castration émotionnelle)، يدفع بعض الشباب (خصوصا مع الميل الحضاري الحالي نحو رقة مشاعر أكبر) لكسر طابو حظر المشاعر والضعف. ليس من خلال التعبير المباشر عن أنفسهم. بل متوارين خلف رداءات مقنعة. مُستحضرين كلام بعض الفلاسفة والأدباء الذين يتسمون بالتشاؤم والعدمية والإحباط. والذين صارت اقتباساتهم تحقق نجاحات منقطعة النظير: كالفيلسوفين الألمانيين آرثر شوبنهاور ونيتشه، والفيلسوف الروماني إميل سيوران، وكذا الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي والتشيكي فرانز كافكا…إلخ. وكلهم يلجؤون إلى نوع من تسامي المشاعر sublimation ليعبروا عن أحاسيسهم بجُمل جديدة مبتدعة لم تفقد بعدُ رونقها، وصيغ جميلة راقية لا تخدش رقة المتلقين.
إن محتوى الفيسبوك يُعبر عن نقائص الواقع. فهو بمثابة ملاذ للتعويض عن الحاجات التي لا يُمَكِّن الواقع من تلبيتها. ضاربا بعرض الحائط كل وسائل الردع المجتمعية من منع وردع وإقصاء اجتماعي exclusion sociale والتي غايتها الوصول إلى نوع من التماهي الاجتماعي بين كل الأفراد conformité sociale. لهذا صار على المجتمع أن يبدع أشكالا جديدة لاحتواء أفراده.