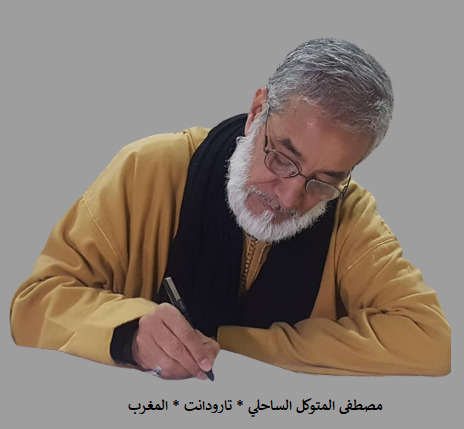عندما نَمُرُّ بالفنِّ مرور الكرام …!

دعونا نسترق السمع
د. محمد بدوي مصطفى
افتتاحية: الموسيقى غذاء الروح:
لا أخفي عليكم يا سادتي أنني عاشق حتى الثمالة، أقصد للفنون والموسيقى! وهذه حقيقة هبة من رب العالمين، تجدني شاكر لها في كل لمحة ونفس، فشعراؤنا الأفذاذ علمونا العلوم حينما قالوا: «كن جميلًا ترى الوجود جميلًا».
نفحات في يوميَّاتنا، تتهادى إلينا من كل صوب وحدب ونحن في وحشة ووحدة في ترهات حيواتنا اليومية اللهم إلا من ايمان راسخ. تصل إلينا تلك النفحات العبقة ببراق الشوق دون أن نقصد أو لنقل بمحض الصدفة، وهذه بلا شك هبة وهدية من ربّ جوّاد كريم، إذ أنها قادرة في برهة ولحظة بأن تُدخل السرور إلى النفوس وتُلهِبُها لوعة كنار المجوس. فما بالكم يا سادتي بمن يقف/تقف ويمتعنا بتراتيله، بغنائه أو عزفه أو فنّه في صحن أسواقنا وفي قوارع طرقاتنا المزدحمة فقط بآهات الكورونا وبالصمت القابع عليها؟! هل يسعد هو نفسه، عندما يرى آي البهجة، السعد والفرح على وجوهنا المشرئبة تجاهه، وهو يحرك قوس كمانه تارة أو يترنم بريشة عوده تارة أخرى أو يتلو من خلجات قلبه على مقامات الخلود من «نهوند» فارس و»حجاز» أم القرى و»كرد» بابل أو حتى بريشة ألوان أو بطباشيرة تتهادى وتتمايس راقصة لتجسد لنا الموناليزا، الجكوندا، ماري أنطوانيت، أو ساحرة الفرس – بطبيعة الحال – على الطبيعة في التوّ واللحظة. هذا فنّ وسعد سخرّه البارئ لنا في تلك اللحظة فهل هي الصدفة أم هي مِنَّة مِنْهُ عن قصد جاءت ببراق المراسيل؟
«النون» في الفن وتعابير إنسانية:
إن الفنون يا سادتي بكل تجلياتها ما هي إلا تعابير إنسانية وبجدارة، تتفتق خلجات القلب الحالم لدغدغاتها وتبتسم لدندناتها وترقص لموسيقاها مرحًا وطربًا، وتنداح سحائب الكدر والغمّة من النفوس بلا رجعة من موازيرها وعلاماتها سواءً «بالدييز» أو حتى «بالبمول». كل امرئ منّا، المُسمِع والمستمع على حدّ سواء، تسوقه هذه اللغة العالمية وبإحكام، دون أن يدري وكأنّه مُسيّر لا مخيّر، لتقوده إلى ذاك المكان المجهول، لا الفنّان خطط سلفاً أن يكون به في تلك اللحظة ولا حتى المستمع. يقف كل منهما بجانب من جوانبه حتى يستطيع أن يفرغ مجموعة من الشحنات الكهربائية الجائشة بدخيلته، إن أردنا، سالبها وموجبها، دعونا نسميها انفعالات أو لنطلق عليها مصطلح اختلاجات أو هسترة متناسقة تنتظم فيها رموز هذه اللغة في تناغم منقطع النظير لتخرج لنا خلاصة هذه الشحنات على شاكلة مقطوعات أو معزوفات، لوحات تدق على أوتار حسٍّ مرهفٍ بفؤادٍ عليل أثقلته هموم الحياة، وتلعب ساعتئذ بحناياه وبدواخل الذاكرة لتفرغ كل ما بجعبتها من آيات وأنغام متمثلة في كل شيء جميل متناغم وحاملة بين طياتها لحن الكمال، أقصد هنا كمال النفس المولعة بكل ما تتضمن تلك الكلمة المتمثلة في حرفين، وقد شدد آخرهما وهو النون: «فَ نّ». كلمة ختامها مسكٌ ولو غيرنا آخرها لانقلبت لمفردة «نور» وكلاهما (ن – ر) حرف شمسي. فالنون حرف مفتاح في لغة الضاد يشع نوره وكأنه هلال العيد يبتسم من علٍ ويقتبس هاهنا بشكله النصف دائريّ من القمر(ي) صفات البهاء والجمال. والنون ككلمة أو كحرف، لعمري نهج من أنهج كتاب انزلت آياته وأحكمت، تتجلى في اقترانها بمفردة «قلم» ومن بعد بكلمة «يسطرون»، وتسحضر آية تبدأ بكلمة مفتاح «اقرأ»، وكلها تنطوي عن سر الكون وابداعات الخالق في خلقه «، وفيما وهب الخلق من إمكانيات وأدوات بل ومقدرات تعكس جمال الخليقة عبر تجسيد الفن الرباني، وبكل أشكاله وبلوراته في شتى بلاد الله الواسعة فهل من مدكر؟! لعمري … إنّ الله جميل يحبّ الجمال فكيف عباده لا يعشقون؟!
الوجدان وتفاعلاته مرآة لدواخلنا:
من منّا يا سادتي من لا يتفاعل وجدانيا وفكريًا مع أصوات ربانيّة كصوت السيدة أم كلثوم أو السيدة فيروز، ألا نحس بهما إحساسًا عميقاً وننفعل بفنهما متجاوبين منفعلين بشتى التراجم وبأشكال تفصح عنها أرواحنا وصفاتنا المتباينة التي خلقنا بها الله؟ فمنَّا من يرقص ويتراقص ومنّا من يميس ويتمايس أو يترنح طربًا ومنّا من تسكرهم هذه الأنغام، حينما تتهادى إلى مسامعهم ألحان على مقامات عدّة، قائلة بكل أدب واحترام، وذاكرة لصوفية الطرب في أرقى تجلياته: هل «رأى الحب سكارى» ويمكن لنا أن نغير الكلمة الثانية في الجملة لنقول: «هل رأى الفنّ سكارى»؟ فتعلو بالفنون المتباينة الأرواح وتسمو يا سادتي إلى برازخ الصفاء في رسائل إخوان الصفاء إن أردنا، وبالأغاني عند مريديّ أبو الفرج الأصفهاني.
ما أجمل الاصغاء للموسيقى والإنشاد في الهواء الطلق أو في أماكن ما كنّا نتوقع أن نتموسق فيها، عندما نكون في سباق خلف المترو أو خلف الحافلات أو بين أزقة الأسواق نتنقل ولا ندرك قيمة من وقف أمامنا يرتجل كل هذا الجمال في مسرح فريد، خُلق فقط له وبِهِ في تلك اللحظة وبتلك البقعة. إننا يا سادتي لا نسمع ساعتئذ مجرد أنغام على شاكلة موجات، بل نستقبل أغلب الظن حبال الوصل بيننا، تجمعنا لحظئذ بوتقة تحوي الفنان ومن اجتمع حوله. فإن وقفتنا تلك يا سادتي ما هي إلا إجابة ضمنية لصبرنا أولًا ولرضانا التام ثانيًا لما يقوم به المبدع من دأب أو فنّ. نتواصل في تلك اللحظة بيننا وتلتقي أرواحنا في سماء واحدة ولا تنفرد أذهاننا إلا بها. أليسه إذن وسيلة اجتماعية وتربوية فاعلة تساهم في عملية التفاهم وترقى بكل ما يتعلق بتنمية الحس الداخلي لكل إنسان؟ فضلًا عن أنها تساهم في تغلغل آيات الفرح وتخلل الغبطة إلى نفوسنا التي ربما كسرتها وتيرة وروتينية مطرقة الدأب اليوميّ المضني أو ربما عصرتها مشقات الحياة ومسؤولياتها التي لا تنتهي. الفنون يا سادتي تُجَمِّل عالمنا الصغير لتمتد منه إلى كل العالم من حولنا، وكما قال سيد درويش في إحدى مقطوعاته الخالدة: «غني لي شوية شوية … غني لي وخد عيني». وما أجمل عجز البيت، بمعنى: خد أجمل ما أملكه في حياتي: العينين أي بصري؛ هي لك سيدي أو سيدتي عرفانًا فقط أطربتني بأغنية. يا للجمال! وفي البيت التالي تقول أم كلثوم في هذه الأغنية السيد درويشية: «المغنى حياة الروح … يسمعها العليل تشفيه وتداوي قلب مجروح احتار الأطباء فيه» … إلى آخر الأغنية. والحديث لا يحتاج مني إلى تفصيل!
الموسيقى دعامة التبادل بين الشعوب:
وأخيرًا دعوني أقول إن الموسيقى هي دعامة التبادل بين الشعوب لأنها لغة توحدها وتجعل منها شعب واحد وقلب واحد بنبض واحد، تدعم التآخي وتوثق الصلات بيننا وتديم المودة وتسهل التعاون وتقارب القلوب المنكسرة الغاضبة من بعضها البعض سواء على صعيد خاص أو على المستوى العام أو العالمي وحتى بين مختلف الشعوب على وجه الأرض ودعونا نتذكر أغنية «نحن العالم» التي تغنت بها مجموعة كبيرة من المغنيين العالمين في ثمانينات الألفية المنصرمة وجمعوا بها خيرًا كثيرًا من أجل المجاعة في إثيوبيا التي أثقلتها وقتذاك الحروب ودمرها الاقتتال بين أبناء الجنس الواحد. وكأنّ العالم في تلك اللحظة قد أجتمع كله ليغني للسلام وينادي بالأمن لذلكم البلد الذي لو لا هذه الصرخة المدوية، لصار نسيا منسيا، ولكان في عداد الغابرين، لولا تضافر المغنين وأهل الفن، حيث رفعوا اسمه في كل المحافل؛ فالموسيقى يا سادتي قادرة أن تحرك الجبال. فلا تمروا يا سادتي أمام الفنّ ومقاماته مرّ الكرام! تمهلوا واصغوا وغذوا به أرواحكم، سواء بآيات مرتلة، بإنشاد صوفيّ، أو بمزامير مموسقة أو بألحان سامية تتجلى في معزوفات أو نبرات أو خلجات أو بدندنات على قارعة الطريق.
جوشوا بيل … عازف الكمان العالمي
في مترو الأنفاق بنيويورك:
في هذه الأيام الصارمة التي لسعتنا بسياط الكورونا ازدادت وطأة الأعباء والمسؤوليات، اقتصادية، اجتماعية، الخ، لقد فقدنا حرية الخروج بسبب الاغلاق وبعضنا بسبب الحجر الصحي، أرانا منغلقين في بيوتنا أو ربما ممنوعين من التوفق ولو لبرهة أو بضع دقائق للتملي في بعض ارهاصات الفنّ التي قلّت فقط بسبب الجائحة الملعونة. نبحث هنا وهناك أين هم هؤلاء الفنانون، الممثلون، الموسيقيون؟ لا أثر لهم وإن وجدوا في ركن من أركان مدننا الخاوية على عروشها فليس لنا الحق في الوقوف ولو للحظة لنستمع إليهم ونصغي ناهيك أن ننطرب أو حتى أن نتأمل لوحة فنية رسمتها ريشة مبدع اقتعد زربية على الأرض ليجسم بالألوان ما يفوق التصور.
هناك عدّة أسباب دعت النجم العالمي الشهير وعازف الكمان الأمريكي جوشوا بيل أن يقرر إعطاء واشنطن سانحة أخرى لتقدير الثقافة وتبجيل الفن وأهله فقد اعتزم العزف مجددًا في محطة مترو الأنفاق في العاصمة بعد أن فشلت تجربته الأولى في عام ٢٠٠٧ في جذب الجمهور المتسارع تحت الأنفاق للانتباه إلى فنّه الرفيع وإلى عزفه الخارق للعادة. فهل ذاك إدراك حسيّ أو لا إدراك ربما سقط طيّ الهذيان اليوميّ في قارعة الطريق؟ على كل حال لم يستطع جوشوا بيل بجلالة قدره أن يتجاوز النتائج المخيبة للآمال والمريرة له التي حققتها تجربته الاجتماعية مع صحيفة واشنطن بوست حين عزف متخفيًا لمدة ٤٥ دقيقة مقطوعات موسيقية لعمالقة الموسيقى الكلاسيكية بجدارة كبيتهوفن وباخ داخل محطة المترو في محاولة لمعرفة درجة الإدراك الحسيّ ومدى التذوق الفني عند البشر في بيئة عامة مزدحمة وفي وقت غير ملائم. لم يقف له سواء ستة اشخاص فقط بينما مرّ به آلاف الناس مهرولين ومارين مرّ الكرام دون أن يلتفتوا إليه أو حتى أن يسترقوا السمع. وفي تلك التجربة قدم له فقط نحو عشرين شخصًا مساعدة مالية وقد كانوا في عجلة من أمرهم. ولم يجمع العازف في تلك الدقائق إلا 32 دولاراً. وعندما أنهى جشوا مقطوعته الأخيرة لم يلاحظ الناس الموجودين الصمت الموحش الذي حل محل ألحانه الجميلة، بل ولم يصفق أو يهتف له أحد، ولم يحاول أي شخص أن يثنيه عن الرحيل ليعاود عزفه الجميل مجدداً! والسؤال الذي يطرح نفسه هاهنا: هل نراعي نحن للمبدعين في حياتنا، وهل تأخذنا اللهفة لنصغي ونسترق السمع إليهم، وهل نرى من ابداعهم الجبار هذا شيئًا؟ أم أننا صناديق مؤصدة، مغلقة بالشمع الأحمر؟ أو ربما ننتظر فلان وعلان ليقول لنا: هذا فلان، قدم حفل في حضرة الملك أو الأمير أو الرئيس فلان، فحينئذ نبدي له التبجيل والتقدير، وإن مررنا به بعد بضعة أيام وهو يعزف متنكرًا على قارعة الطريق فلن نعره أي اهتمام … وهكذا الحياة وهكذا نحن بنو البشر … وهل تأخذنا في الفنّ لومة لائم؟
من هذا جوشوا بيل وما القصد من التجربة؟
يطول الحديث عن جوشوا بيل وهو حقيقة غني عن التعريف والتقديم والتعقيب. له مسيرة حافلة بالأوسمة وبالنجاحات، فقد حصل جوشوا بيل على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية من ضمنها جائزة أفضل عازف في أميركا لعام 2010 وجائزة آفيري فيشر وجائزة غرامي لأفضل صولست مع الأوركسترا كما عُيّنَ في منصب مدير أكاديمية سانت مارتن المرموقة، وهو أول موسيقي ينال هذا المنصب بعد السير نيفيل مارينر مؤسس الأوركسترا عام 1958. تصل في العادة ثمن تذكرة حفلاته الموسيقية إلى ما يقارب المئة دولار، ويحضرها الآلاف كل مساء.
لكن لم يدرك الآلاف من الناس الذين مروا به في ذاك اليوم دون أن يعره أحدهم نظرة ولو سريعة أنه أحد أشهر وأبرع عازفي الكمان في العالم على الإطلاق، كما لم يستطيعوا أن يميزوا أنه كان يعزف أصعب وأشهر المقطوعات الموسيقية باستخدام آلة كمان أغلب الظن صناعة مايسترو إيطالي يدعى سترادي فاري، ويقدر ثمن تلك الآلة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار.
هذه يا سادتي قصة حقيقة وليست من وقع الخيال لكنها تُعلمنا أشياء كثيرة عن أنفسنا. نشأت الفكرة عندما دعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية العازف جشوا بيل ليقضي مدّة ساعة أو أقل في دهاليز مترو الأنفاق بمدينة نيويورك ليقدم بعض من فنه الرفيع. أرادوا عبر تجربة اجتماعية أن يختبروا وعي المارة وذوقهم العام وأولويات تهمهم في غضون حيواتهم المزدحمة بالمسؤوليات.
تساؤلات أخيرة عن نتيجة التجربة ومآلاتها:
لقد رمت صحيفة الواشنطن بوست في تجربتها هذه أن تجد إجابات صائبة على أطروحات وتساؤلات عديدة منها:
• أيشعر المرء بموطن الجمال حوله إذا كان في مكان عام وعادي؟
• أتجذبه آيات الجمال إليها وهو في غمرة شؤونه الخاصة خلال اليوم؟
• متى يقف ليعبر عن تقديره واعجابه بذُوي المواهب الفنية البارعة؟
• أيستطيع اكتشاف المواهب والتعرف على الموهوبين على قارعة الطرق بسهولة؟
إن كل الأسئلة التي طُرحت أعلاه ربما تخطر ببال بعضنا أو قلة منّا، لا سيما ببال أولئك الذين يتهمون بالفن، ولكن يبقى في حناجرنا بعض من مذاق مُرّ بنهاية هذه التجربة؛ ألا وهو أن غالبية المارّة في تلك التجربة وحتى في التجربة التي تلتها وقام بها أيضا جوشوا بيل، لم يقفوا، أو يتمهلوا ليسترقوا السمع لأشهر من يعزف بهذه الآلة على وجه الأرض حيث تقلد قوسه ليعزف أجمل ما أبدعته الموسيقى الكلاسيكية على الإطلاق فضلًا عن إنها أشهر مقطوعات انطبعت بذاكرتنا الجمعية. فليستخلص كل منّا التعاليم المفيدة من هذه التجربة التي ربما تحدث لأي منّا في خضم حيواتنا المختلفة. ولنختم الموضوع بقصيدة في الفن:
يقول نجيب الكيلاني:
عشقت الفن لا للفن لكن للذي أسمى
وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما
عشقت الفن معراجا إلى غاياتنا الشما
أردد فوق قيثاري نشيداً يشعل الهمة
يذكرنا بماضينا ويجلو عنه ما غما
ويوقظ هاجع الآلام كي لا نقرب النوم
أريد الفن أن يلهب روح الغضبة الكبرى
يشكل جيلنا الحيران يذكي فكره الحُرَّا
يفيض على الربى عدلاً ويملئ روضها بِـرَّا
*رئيس تحرير الجريدة العربية الدولية المدائن بوست