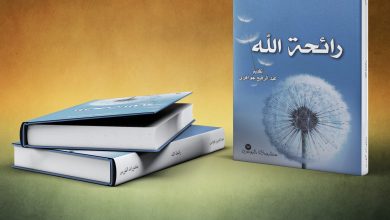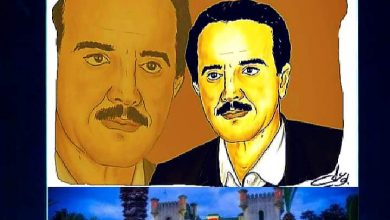أحمد رباص – حرة بريس
لنعد الآن إلى دوار آيت تاركلمان المجاور لدوار آيت حمو أوسعيد، هذا الأخير المضاف إليه المدرسة الفرعية في صيغتها النكرة، فيقال: مدرسة آيت حمو أوسعيد، دون أن يشار إلى جاره في هذه التسمية، مع أن المدرسة إياها وضعت أصلا لتقديم خدماتها التربوية والتعليمية لأطفال كلا الدوارين. وقد مررنا في ما سلف من هذا الحكي على الإشارة إلى ذات المفارقة.
خلال المدة الزمنية التي كانت بمثابة رأس السنة الدراسية 1989-1990 والتي قضيتها صحبة المعلم الورزازي تحت سقف مسكن طيني غير ذي نوافذ يقع في قلب دوار الحراطنة اللايشار إليه في الوصف الذي يحيل على المدرسة، (خلال تلك المدة) نشأت علاقة من نوع خاص بيني وشابة سوداء البشرة تسكن في منزل مجاور لمرقدنا المظلم آناء الليل وأطراف النهار. كنت أراها في كل يوم تقريبا، ولاحظت مع توالي الأيام أنها تلاطفني بنظراتها وتقول لي باللغة الغاوية الناطقة بها عيناها الكحيلتان: مرحبا بك يافرس أحلامي، كلني يا ولي الله، يا من ساقته الأقدار والصدف إلى مربضي ومرتعي..بدوري كنت أجيبها بنفس اللغة، لغة النظرات الصامتة والضاجة بالمعاني: مهلا، يافتاتي، هوني عليك..هل تريدين وضع سمعتي في كف عفريت؟
كان منزلنا المكترى يقع في جهة من الدوار الأقرب إلى الحقول والبساتين التي تسقى من ماء النهر وفق نظام عرفي محكم ومتوارث جيلا عن جيل. للتزود بالماء الشروب، كنا نقصد بئرا لا تفصلنا عنه سوى خطوات معدودات في اتجاه ضفة النهر. ذات يوم، قررت الخروج لأروح على نفسي بعد شعوري بشيء من الملل والقنوط. وما كدت أطل برأسي إلى الخارج، حتى رمقت بنت الجيران الأهالي وهي تسير نحو البئر. تبادلنا كالعادة نظرات خاطفة، لكنها كانت أكثر إقناعا وإلحاحا بالنسبة لي بحيث حملتني على الاستجابة الفورية لندائها، مستغلا كل الحركات والإشارات التي يسمح بها جسدي، ما عدا لغة الكلام. وهكذا، فما كادت تصل إلى البئر حتى لحقت بها في رمشة عين. ابتسمت لي ولم تصدر عنها أدنى حركة أو نأمة تنم عن خوفها أو رغبتها في الهرب. أمسكت بكلي نهديها المكتنزين وداعبتهما قليلا دون مقاومة منها تذكر. في هذه الأثناء، تراءى لي شبح الفضيحة يطل بهيبته الرهيبة، فارتعبت ولعنت شيطان النزوة العابرة (للقارات)، فقفلت راجعا إلى جحري تاركا الشابة السوداء في حالة من الذهول اللايوصف.
مرت تلك الأيام كالسحاب في تواز مع انسياب مياه واد درعة تحت جسر تانسيخت البعيد عن هذه الديار بحولي سبع كيلومترات، وانتقلت إلى دار قديمة مهجورة. هي أيضا، كما تعلمون، جدرانها من تراب وسقوفها من أخشاب، وتقع في منتصف المسافة الفاصلة بين الدوارين. هنا سكنت بمفردي خلال ما تبقى من شهور العام الدراسي المومئ إليه في الفقرة الثانية من هذه الحلقة. في كل ليلة، كان لي موعد مع ثلة من شباب دوار آيت حمو أوسعيد، الذين كان حضورهم بجانبي يساهم، بقسط كبير، في تبديد إحساسي بوحشة المكان وتعزيز شعوري بالأمان. هكذا طويت صفحة فتاة آيت تاركلمان ونسيتها تماما من بالي.
في بداية السنة الدراسية الموالية، كنا – نحن معلمي م/م آيت خلفون أمام – تنظيم تربوي جديد، من أبرز سماته وفود ثلاثة معلمين جدد، كلهم متدربون، حديثو العهد بالتعيين الأول ضمن آخر فوج. أطولهم يتحدر من آسفي وأقصرهم ينتمي إلى منطقة زاكورة، بينما أوسطهم ينحدر من الدار البيضاء. هذا التدرج على مستوى قياسات أطوال المعلمين الثلاثة يقابله تدرج آخر على مستوى ألوان بشرتهم. فالأول بشرته بيضاء إلى حد ما والأقصر بشرته شديدة السواد، فيما أوسطهم بشرته سمراء بين بين..
جاء تعيين هؤلاء المعلمين لتعويض الخصاص في المدرسين الناجم عن انتقال المعلمتين – المتزوجتين بشابين كلاهما يدير مقاولة بناء واللتين عملت معهما طيلة السنة الدراسية الماضية – إلى نيابة مراكش. وبما أن زميلي الورزازي قرر الانتقال إلى المدرسة المركزية الواقعة في قلب دوار آيت خلفون بدعوة من المدير الذي كان يعرف أباه قيد حياته، مثلما صرح له بعظمة لسانه في أول لقاء بينهما، اقترح على الوافدين الجدد الإقامة في الكوخ الذي كان يأويه. وهكذا أصبح هذا المنزل ملاذا لثلاثة معلمين عزاب عوض معلم أعزب واحد. لا زلت أذكر كيف أنهم أحسنوا معاملتي نظرا لطيب معشري. لهذا، دعيت مرارا إلى أن أشاركهم طعام غذائهم.
في بداية السنة الموالية، انتقلت للعمل في مدرسة آيت املكت البعيدة عن مدرسة آيت حمو أوسعيد بكيلومترين تقريبا والقريبة من المدرسة المركزية بمدى مرمى حجر (بالمقلاع، طبعا)..الشقة بعدت، السبل تفرقت بنا وأواصر التواصل في ما بيننا انقطعت..
سارت أيام وجاءت أخر..طوحت بي الأقدار في أرجاء إقليم سطات معلما تابعا لنيابته نتيجة مشاركتي بنجاح في الحركة الانتقالية الوطنية التي أعلن عن نتائجها يوم توقيع محضر الخروج للعطلة الصيفية الموافق ل1993/06/30 حيث علقت لوائح المستفيدين من معلمي ورزازات على أحد جدران نيابتنا الأصلية. وما كادت تباشير خريف نفس السنة تلوح في الأفق، حتى التحقت لأول مرة بم/م الحدادة الواقعة في النصف الشمالي لمنطقة بولعوان التي يخترقها نهر أم الربيع ويشطرها شطرين.
لم أعد أذكر في أي يوم من سنواتي التسعة – التي أفنيتها عطار جائلا بين دواوير بادية سطات وموزعا للمعرفة على صغارها – تناهى إلى علمي من أحد الزملاء خبر رحلة الشابة السمراء، وهي حامل في شهرها التاسع، من ورزازات إلى سطات بحثا عن الأب البيولوجي للجنين الذي “يفركل” في أحشائها. تبين لي من خلال ذكر الاسم الكامل لزميلي الذي فتنته الغواية وخذلته الدراية، ولئن دل لقبه العائلي على الإبداع، أن الأمر يتعلق بالمعلم الأسمر الأوسط بين الأطول الأبيض والأقصر الأسود. قيل لي حينذاك إن مشروع الأم العازبة سافرت إلى مدينة سطات بمفردها، دلالة على أن أهلها وذويها تركوها تواجه مصيرها لوحدها نكاية في طيشها وإصرارا على عقابها. غير أن أبجديات دليلها الذي سارت على هديه استقتها أول الأمر من من المؤسسة الأصلية التي كان “صاحب دعوتها” يعمل فيها قبل انتقاله إلى نيابة سطات، وهكذا حازت المعنية بالأمر على معلومات صحيحة عن مكان تواجده ومقر عمله، بالإضافة إلى إرشادات وتوجيهات تلقتها من جهات مدنية ومصالح إدارية طرقت أبوابها أثناء مسار رحلتها.
في نهاية المطاف، وصلت الشابة الحبلى إلى المدرسة المركزية لم/م القرارة في منطقة بني مسكين من ضواحي مدينة البروج، فخرج مدير المؤسسة لاستقبالها. رحب بها وبادر إلى سؤالها عن غرضها من هذه الزيارة. أجابته قائلة: أريد من فضلك أن تدلني على المعلم فلان الفلاني اللي حملني في الدوار ومشى وخلاني..لما سمع المدير كلام المرأة الحامل، دعاها فورا إلى امتطاء سيارته وانطلق بها مسرعا نحو المدرسة الفرعية التي يعمل فيها صاحبنا. ما كان الأخير مغتصبا لأن الشابة لم تعد قاصرا ولأنها مارست معه الجنس عن رضى خاطرها. توقفت السيارة عند مدخل المدرسة، ترجل منها المدير طالبا من مرافقته أن تبقى واقفة عند الباب في انتظار إحضار “صاحب حاجتها”. في أقل من دقيقة أو دقيقتين، جاء المسؤول بالمعلم الهارب الذي ما أن رأى صاحبته وهي حامل حتى “كحل بالعمى”، وسرعان ما أخذ بيدها داعيا إياها إلى الدخول إلى بيت الزوجية في أفق استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية.