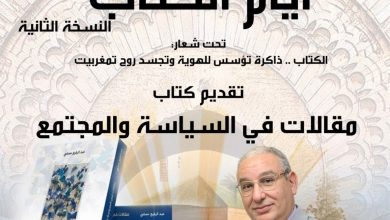ليس من قبيل التهويل أن نقول إن أغلب المشاريع المجتمعية تفشل، لا لأنها بلا تمويل أو بلا فكرة، بل لأنها تُبنى على فاعلين يلعبون أدوارهم بدل أن يؤدوها، ويمثلون رسالتهم بدل أن يتمثلوها. ذلك أن الفرق الجوهري بين الأداء والتمثيل، وبين التمثل والتمثيل، يحدّد مصير الفعل ذاته: هل هو فعل تحويلي أم صدى أجوف؟ هل هو صراع من أجل المعنى، أم مصارعة رمزية من أجل التموقع؟لقد أصبحنا في كثير من السياقات نرى “المناضل” يتحول تدريجيًا إلى “مصارع”، لا لشيء إلا لأن الحلبة تغيّرت: من فضاء نقدي تحرري إلى مشهد استعراضي محكوم بحسابات التموضع والتأثير اللحظي. المصارع لا يهمه عمق الرسالة، بل مدى بريقها. لا يهمه أداء الدور من موقع الوعي بالمسؤولية، بل استعراضه من موقع الرغبة في الاعتراف الخارجي. والمفارقة أن هذا “النضال الاستعراضي” كثيرًا ما يحجب الصراع الحقيقي بدل أن يفضحه، ويُخدِّر الذاكرة بدل أن يُوقظها، ويُنتج شعارات مرتاحة بدل بدائل متألمة.من تمثيل الرسالة إلى تمثلها : الفرق دقيق وعميق: تمثيل الرسالة هو تقمصها خطابًا أو مظهرًا؛ أن تقول “أنا حامل للرسالة” دون أن تحمِلَها فعلاً، دون أن تُحمِّلك هي ما يكفي من شك وصدق وثقل أخلاقي. أما تمثل الرسالة، فهو أن تنصهر فيها، لا كقيدٍ هوياتي بل كمرآة لمساءلة الذات، وأن تعيشها في التفاصيل اليومية، لا في المناسبات الاحتفالية.ولعل من أهم ما يجب التنبيه إليه، أن الانتماء إلى الفضاءات التنظيمية أو الحزبية لا يعني بالضرورة الانتماء إلى معايير النضال أو أخلاقياته. فليس كل منخرط في حزب ما مناضلًا، إذ قد يكون المنخرط باحثًا عن تموقع، أو ممارسًا لوظيفة، أو مجرد حامل لبطاقة، دون أن يلتزم حقًا بأفق تغييري يُحاسب فيه نفسه كما يُحاسب غيره. وبالمثل، ليس كل سياسي حقوقيًا، ولا كل حقوقي سياسيًا؛ فالسياسي قد يستعمل خطاب الحقوق كتكتيك ظرفي، دون التزام فعلي بمنطقه. والحقوقي، حين ينعزل عن فهم الموازين السياسية والاجتماعية، قد يسقط في التقنوية أو الشعبوية. وحده من يتمثل الرسالة ويتجدد في ضوئها يمكن أن يجمع بين الموقف الحقوقي والحس السياسي، في أفق تحويلي لا انتهازي.النضال بوصفه فعلًا لا فرجة : النضال، حين يُفرغ من بعده النقدي التوقعي، يتحول إلى حرفة للظهور، لا محنة للتحول. إلى مهارة في اجتياز مشاريع التمويل والتكوين، لا في بناء بدائل للعيش والمعنى. إلى نمط في الكلام عن الديمقراطية، لا في ممارستها داخل الفضاءات الضيقة. وهو بذلك، لا يصنع أثرًا، بل يُعيد إنتاج العبث.أما المناضل الحقيقي، فقلّما يُرى في الأضواء. إنه هناك، حيث لا تُصفَّق الكلمات، بل تُوزن المواقف. حيث لا يُستهلك النضال في اللافتات، بل يُعاش في المفاصل. المناضل ليس فقط من يصارع من أجل قضية، بل من يراجع ذاته في كل صراع. من ينصت أكثر مما يتكلم. من يترك أثرًا لا ذكرى.حين تصبح اللغة لعبة والنضال عرضًا : رغم أن اللغة فكر، وأنها تعكس تصورًا للعالم، فإنها أيضًا لعبة تُمارَس بقواعد، وتُبنى بعباراتٍ قد لا تحيل دائمًا على مضمونها الواقعي. فاللغة، حين تتحول إلى أداة للتخايُل السياسي، قد تُنتج خطابًا يُوحي بالنضال دون أن يَسلكه، وتُفرز شعارات تُجَمِّل الواقع بدل أن تفضحه. في هذه اللعبة، تصبح القواعد النحوية أشبه بقوانين رمزية تنظم توزيع الأدوار داخل الخطاب: من يُسمّى مناضلًا، ومن يُقصى، من يُنصّب متكلمًا باسم الجماعة، ومن يُؤطَّر كـ”غير ناضج” أو “غير مسؤول”.وفي هذا السياق، تصبح السياسة لعبًا لغويًا متخايلاً على النضال: إنها لا تخلق الواقع، بل تُمسرحه. لا تلتزم بالمعنى، بل تُعيد ترتيب رموزه لخدمة تمثلات الهيمنة أو الادعاء بالتغيير. وهكذا، حين ينفصل النضال عن لغته الأصلية – لغة المعاناة والتحوّل والمساءلة – يغدو مسرحًا شكليًا يُعيد إنتاج نفس البنية التي يدّعي مناهضتها.هذه البراغماتية الجديدة، وإن بدت “ذكية” في ظاهرها، تُفرغ الفعل من جوهره، وتحوله إلى وظيفة تموقع لا مخاض تحوّل. وبهذا المعنى، يُصبح المناضل مجرّد جهاز لرصد الإعجاب الجماهيري، لا حاملًا لمعنى ولا صاحب رؤية.عن السلطة والهيمنة الرمزية : السلطة لم تعد تُمارَس فقط عبر القمع، بل تُعاد إنتاجها داخل فضاء الخطاب والتمثلات. لقد صار النضال نفسه مجالًا للهيمنة: حيث تُفرَض معايير “النضالية المقبولة”، ويُعاد ترتيب الفاعلين بناءً على قابليتهم للتماهي مع مقاييس النظام لا مع ضميرهم النقدي.في هذا المناخ، تُهيمن السلطة الرمزية حين تُستبدَل المقاومة بالتطبيع، والمسؤولية بالانقياد، والنقد بالخضوع المغلف في بلاغة الخلاف. بل حتى بعض المقاومات الجديدة تُستعمل كواجهة لتزيين الهيمنة، بدل أن تفكك منطقها. وهذا هو الوجه المعاصر من الاستبداد الناعم، حيث يُدار النضال نفسه من داخل آلة الهيمنة.من ضرورة الإزعاج إلى استعادة ضمير الفعل : إن أخطر ما نعيشه اليوم ليس فقط ابتذال النضال، بل قبول هذا الابتذال كواقع طبيعي. ذلك أن سقوط الوعي في العدم والإلحاقية يجعل الفاعل لا فقط فاقدًا للمعنى، بل مساهمًا في تغييبه. إننا بحاجة إلى فعل يُزعج لا يطمئن، إلى صوت يتورط في مساءلة ذاته قبل مساءلة الآخر، إلى مشروع يتحرر من غواية الأدوار والأقنعة، ليستعيد جوهر النضال كفعل تحويلي، لا مجرد وظيفة تمثيلية.إن النضال، في أصله، سؤال أخلاقي قبل أن يكون صراعًا سياسيًا. هو معركة في وجه الابتذال قبل أن يكون مواجهة مع الخصم. هو التزام مفتوح على الألم والمجازفة، لا على المردودية والتزلف .شكرًا لتوفير النص الكامل. إليك الفقرة التي طلبتَ إضافتها، مدمجة في ذيل النص بأسلوب متناسق مع نبرة الخطاب التحليلي النقدي:—غير أن استعادة جوهر النضال لا يمكن أن تتم دون مساءلة ذاتية عميقة للفاعلين أنفسهم، سواء كانوا داخل السلطة أو في معارضتها. ففي كثير من السياقات، يستوي الفاعل الموالي مع المعارض، فكلاهما – إلا من رحم ربك – لا يتفادى ممارسة إرهابه الفكري تجاه خصومه. بل إن بعضهم، ممن زاغوا عن المبادئ واستسلموا لغواية الاصطفاف، لا يتورعون عن اللجوء إلى أساليب الوشاية والتخوين وأحيانًا حتى التكفير. وهي ممارسات تعكس فاشية فكرية قاتلة لروح الحوار والسلم، تفرغ الفعل النضالي من مضامينه التحررية، وتحوّله إلى أداة إقصاء. الأخطر من ذلك، أن بعض هؤلاء ينزلق – بوعي أو بدونه – إلى تبنّي سرديات أمنية بالوكالة، فيكرّس منطق الهيمنة ذاته الذي يدّعي معارضته. إن النضال الحقيقي لا يُقاس بعدد الخصوم الذين نُقصيهم، بل بعدد المسلمات التي نُراجعها، وبعدد الجسور التي نعيد بناءها على أساس الحرية والمسؤولية والكرامة.
مصطفى المنوزي منسق دينامية ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية