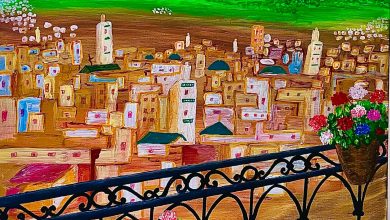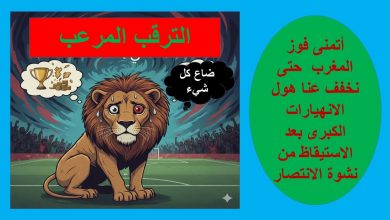على هامش موت حزب كبير الحربائية في السياسة قتل للسياسة.

د عبد الرحمان غندور
عشنا السياسة في جوهرها، باعتبارها فضاء للصراع والتجاذب، وحوار الأفكار وتنافس الرؤى. ونعيشها في هذا الزمن المؤلم، وقد تتحولت إلى مسرح مأساوي وهي تفقد أدواتها الرئيسية، وهي الأحزاب، التي انهارت فيها روحها المميزة وغايتها الأصيلة. في المشهد السياسي المغربي، تتجلى هذه المفارقة بألم صارخ. فالكثير من الهياكل الحزبية، التي يفترض أنها تحمل مشاريع مجتمعية وأيديولوجيات مختلفة، تعاني من تفسخ داخلي يبدأ بتآكل الفكرة وتفسخ القيم وينتهي برداءة الأداء والممارسة. لم يعد الصراع حول البرامج أو اختيارات المسار التنموي، بل تحول إلى سباق محموم نحو التماهي الكلي مع مركز القرار. هذا التماهي ليس تكيفاً سياسياً طبيعياً، بل هو “حالة الحرباء التي تغير لونها لضمان البقاء “، فتتخلى عن الهوية والمبادئ التي كانت تشكل حصانة الحزب و”عذريته” السياسية، فقط للاندماج في جسم النظام الحاكم والاحتماء بالقرب منه.مظاهر هذا الانسلاخ متعددة، وأولها جمود المشهد ذاته. إنه جمود يشبه المستنقع الآسن، حيث تتحرك الأشكال على السطح ولكن دون أي تيار جديد يحمل معه دماءً جديدة أو أفكاراً متجددة. تستمر نفس الزعامات، محتكرة المنابر والمواقع، كأنها قطع شطرنج ثابتة في رقعة لا تتغير. خطاباتهم هي الأخرى وليدة هذا الجمود، خطابات “حربائية” تفتقر إلى الصدق والجرأة، مملوءة بالترميزات والالتفافات، لا يبتغي أصحابها سوى اقتناص الفرص. لقد تحول الحزب من وسيلة لتحقيق المصلحة العامة إلى أداة لتحقيق المطامع الشخصية والتراكم غير المشروع للامتيازات.وهنا يبرز الوجه القبيح للتفاعل مع الفساد. فبدلاً من أن يكون الحزب حصناً منيعاً في مواجهة هذا الداء، يصبح قناة له، أو على أفضل تقدير، شريكاً في لعبة التجميل. إن “شرب منهل الريع” أصبح غاية لكثير من المنتسبين إلى العمل الحزبي، حيث يتحول النضال من أجل الفكرة إلى مساومة على منصب أو عطاء. هذه العلاقة التكافلية بين بعض الأجهزة الحزبية وآليات الفساد تستنزف مصداقية السياسة برمتها، وتجعل المواطن ينظر إلى كل الخطابات بعين الريبة والشك.ولعل أبرز تجليات أزمة “الحرباء” هو تجميد الهياكل الداخلية وتكريس الشيخوخة السياسية. فتمديد الولايات، كما حدث في المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي، هو نموذج صارخ لهذا التجريف الديمقراطي. إنه إجراء لا يعبر إلا عن خوف النخب القديمة من تداول السلطة داخلياً قبل أن تخاف من منافسة الخصوم خارجياً. هذا التمديد هو قتل مقصود لأي أمل في التغيير، وإجهاض لأي طموح لتجديد الدماء. وفي هذا السياق، يأتي تهميش الشباب والكفاءات كجريمة مزدوجة: جريمة ضد الحزب نفسه، الذي يحرم نفسه من طاقات حيوية قادرة على إحيائه، وجريمة ضد الوطن، الذي يُحرم من عقول وكفاءات كان من الممكن أن تثري الفضاء العام. إن إبعاد هذه الطاقات ليس مجرد خطأ تنظيمي، بل هو تعبير عن منطق القلعة المحاصرة، حيث يفضل “أصحاب الجلود القديمة” البقاء في دائرة الأمان الضيقة، حتى لو كان ذلك يعني موت الحزب وهو على قيد الحياة.النتيجة الحتمية لهذه “الحالة الحربائية” هي فقدان الثقة. حين يفقد الحزب “أناه” و”ماهيته”، يفقد شرعيته في عيون من يفترض أنه يمثلهم. يصبح الحزب مجرد ظل للسلطة، أو أسوأ أداة من أدواتها. وهنا لا تكون الخسارة خسارة حزب بعينه، بل هي خسارة للمشروع الديمقراطي برمته. فالديمقراطية تحتاج إلى تعددية حقيقية، إلى خيارات واضحة، إلى أحزاب قوية بفكرها ومستقلة بقرارها، وليس إلى كائنات تستبدل جلودها الأصلية بجلود مموهة بلون الفضاء الذي تقتات منه، فقط لتكتشف في النهاية أنها، بتكيفها هذا، قد اكتسبت ألوانا جديدة، لكن روحها قد فارقتها إلى الأبد. فتمديد ولاية القيادات الحزبية لفترات متعاقبة يمثل إشكالا مؤسسياً في الحياة السياسية عموماً. فعندما يتحول الحزب من مشروع جماعي إلى دائرة شخصية حول زعيم واحد، تنهار معايير الديمقراطية الداخلية لصالح منطق الزعامة.في هذه الحالة، تصبح العلاقة بين القائد والحزب علاقة اعتماد متبادل، حيث يجد الأعضاء المطبوعون بنزعة الولاء، أماناً واطمئنانا على مصالحهم الذاتية في استمرارية ” القائد “، بينما يجد القائد في هذا التفويض المستمر شرعية لمواصلة مساره الشخصي وبقائه في موقع توزيع فتات الريع. لكن هذه الديناميكية تفرغ مبدأ التداول من مضمونه، وتحول التنظيم السياسي إلى كيان بيروقراطي نفعي مغلق.فتجاهل مبدأ التداول على القيادة يؤدي إلى إضعاف للحياة الحزبية، حيث يتراجع دور الكفاءات الشابة، وتغيب الآليات الموضوعية لتقييم الأداء. كما أن تأجيل تجديد الهياكل الحزبية يحرم التنظيم من طاقات جديدة وأفكار مبتكرة، ويحوله إلى كيان يشبه المتاحف أكثر من كونه قوة سياسية فاعلة.التمسك بالقيادات لفترات طويلة يعكس أيضاً أزمة ثقة في الأجيال الصاعدة، وخوفاً من التغيير الذي قد تجلبه القيادات الجديدة. هذه الحالة تخلق فجوة بين خطاب الأحزاب حول التجديد وممارساتها الفعلية، مما يفقدها مصداقيتها لدى الرأي العام، خاصة لدى الشباب الذين ينظرون إلى هذه الممارسات باعتبارها دليلاً على انفصال النخب عن همومهم.